|
دلالات
هذه بعض الدراسات التي
ألفتها
المشترك في الدرس اللساني
الحديث
* صابر الحباشة
قسم اللغة والآداب العربية
بالجامعة
العربية المفتوحة - البحرين
1- في إشكالية المبحث
تعد ظاهرة المشترك، من
الظواهر التي تستقطب
اهتمام كثير من الباحثين
والنظّار، فهي تمتدّ
على كثير من العلوم اللغوية
والشرعية والأدبية. وليس
من الممكن فصل القول فيها
إلا وفق منظور علميّ محدد
يبيّن ما تقوم عليه من
تعدد في التأويل وتنوع
في المناويل. وقد أفرد
الباحثون المعاصرون،
من منطلق لسانيّ، للمشترك
مؤلفات تنوعت بين البلاغة
والمعجم واللغة... ولم نقف
على دراسة باللسان العربيّ
تلمّ شتات هذه الظاهرة،
أو تفحصها فحصا علميا
دقيقا، على النحو الذي
نجده في مصنفات غربية
كثيرة، في هذا النطاق،
ممّا سنشير إليه لاحقا
في غضون هذا العمل. لذلك
رأينا أنّ إفراد الناحية
اللسانية لظاهرة المشترك
بدراسة وافية، أمرٌ يستحقّ
المغامرة ودرب قمن بأن
يُسار عليه.
ومما يزيد الناظر في مبحث
المشترك إغراء بالبحث
ما يُلاحظ من تناقض بين
المراجع في نظرة أصحابها
إلى هذا المبحث، فمنهم
المنكر ومنهم المثبت،
وقد عجّت بهذا الخلاف
كتب اللغة والدراسات
الحديثة التي تناولت
هذا الجانب. أمّا ما يلفت
الانتباه أكثر من ذلك،
فهو أصالة المبحث وتجدد
النظر إليه بين العصور
وبين الألسن، فلا نكاد
نجد لسانا حيّا لم يتطرّق
أهله إلى مسألة المشترك.
غير أنّ المقاربة تتراوح
بين التوسيع والتضييق،
فمنهم من يتناول المشترك
بوصفه ظاهرة معجمية خالصة
لا تمسّ مستويات التحليل
اللسانيّ الأخرى: تركيبا
وصرفا واشتقاقا ودلالةً
وتداوُلا، ومنهم من ينهض
رأيه على تناول المشترك
من زاوية نظر معرفية ذهنية
محضة، تجرّد المسألة
تجريدا وتنأى بها عن التناول
التجريبيّ.
ونجد في بعض المصنّفات
المعجمية إثارة لمسألة
قلق تصنيف ظاهرة المشترك
ضمن حيّز موضوعيّ يصلح
لتعيين حدوده بدقة، حتى
يتيسر تناول خصائصه وسماته
بشكل يقترب من العلمية
اقترابا.
فجاكلين بيكوش مثلا،
تلاحظ أنّ اختلاف عدد
مداخل المعاجم يؤثر في
دراسة المفردات عموما،
ما قام منها على الترادف
أو الاشتراك أو غير ذلك.
وتعتبر قوائم المفردات
في المعاجم الصناعية
متفاوتة العدد بشكل يعسر
معه استخلاص نتائج علمية،
فتعقّد الظاهرة اللغوية
وكثافة المادّة موضوع
الدراسة وتنوعها، كل
ذلك يحول دون استيعاب
المسألة بشكل وافٍ شافٍ.
وترى هذه الباحثة أنّ
"المشترك يفترض آلية دلالية
في منتهى القدرة على جعل
علامةٍ واحدةٍ قادرةً
على أن تمسحَ جزءا هامّا
من التجربة الإنسانية"
. ويبدو أنّ هذا الإقرار
يعلّل لنا أمر افتتاح
جاكلين بيكوش كتابها
عن "البنى الدلالية للمعجم
الفرنسيّ" بقولة اقتبستها
عن جون وكلود ديبوا، يقولان
فيها: "إنّ التمييز الذي
نعقده بين الكلمات المتجانسة
والكلمات المشتركة، لا
قيمة له إلا في نطاق تفسير
ذي طابع زماني تاريخيّ(diachronique).
أمّا على مستوى عمل اللسان،
فإنّ ذلك التمييز يكون
غير ذي دلالة " .
فبالربط بين الشاهدين
الأخيرين نلاحظ وعيا
باستقلالية ما لنظام
المشترك في اللغة، وهو
حدس عملت النظريات الحديثة
على تدقيقه وتأصيله.
وقد ورد في كلام بيكوش
لفظٌ جرى بعدها في دراسات
كلايبار وأضرابه مجرى
المصطلح ألا وهو لفظ "الوجوه"
(les facettes) وإن كان سياق حديثها
عنه سياق الحديث عن الترادف،
فإنّ انسحابه على المشترك
في الدراسات الحديثة
أمرٌ لا نرى داعيا للبرهنة
عليه. فلعلّ "نظرية الوجوه"
قد استنبطت من استعمالاتٍ
للفظ الوجوه مجازيةٍ،
ثم وقع إقرارها باعتبارها
اصطلاحا مخصوصا.
ولعلّ زمن صدور كتاب بيكوش
السالف الذكر (منتصف الثمانينات
من القرن العشرين) يعلّل
طبيعة المقاربة وآليات
المنهج المتبع في الدراسة؛
فقد ركّزت الباحثة على
الناحية النفسية والسيميولوجية،
وهي زوايا نظر كانت محلّ
إعمال في تلك الحقبة. وقد
استعملت الباحثة بعض
المصطلحات مثل وحدة الاشتراك
الدنيا: بوليسم (polysème) وهي -كما
لا يخفى- مَقِيسةٌ على
أخواتٍ لها مثل المورفيم
والسيم والمونيم والستيلام...
وهي تعود إلى الإرث البنيويّ
القائم على التحليل التجزيئيّ
(analyse componentielle). ولا غرابة في أنّ الدراسات
الأحدث لا تعوّل عليها
كثيرا، لأنّها أحدثت
معها قطيعةً معرفيةً،
نظرا إلى تدخّل شبكات
تحليل جديدة لا تكتفي
بالدراسة المجهرية للظاهرة
اللسانية معزولةً عن
سياقها الخطابيّ والتفاعليّ
والتداوليّ والعرفانيّ،
بل تسعى إلى النظر في طبيعة
الأنظمة المتحايثة التي
تسيّر الظاهرة وتتحكّم
فيها بدرجات مختلفة ومتمايزة.
كما وقع تدقيق المقاربة
النفسية الآلية القائمة
على ثنائية المثير والاستجابة،
وهي التي تحكّمت في الأدبيات
النفسية ذات المنزع السلوكيّ
والجشطلتيّ؛ فراجعت تلك
الآلية الصمّاء وليّنتها
باعتماد مقاربة لا تنطلق
من النتائج قبل إجراء
التجارب، بل جعلت هذه
الأخيرة هي التي توصلنا
إلى النتائج دون التخلّي
عن المنهج الاستقرائيّ
والمراوجة بينه وبين
المنهج الاستنباطيّ.
ولعلّ ما يراه غوستاف
غيّوم "نجاحا" لسانيّا
لا يعدو أن يكون سوى تحقيق
توازٍ كافٍ بين المستوى
النفسيّ النظاميّ والمستوى
النفسيّ السيميولوجيّ،
ألم يقلْ اللسانيّ الفرنسيُّ
إنّ "علم النفس السيميولوجيّ
ينحو نحو أن يكون نسخةً
ناجحة من علم النفس النظاميّ"
؟
ويقترح التحليل النفسيّ
الميكانيكيّ عددا من
الأدوات لفهم الظاهرة
اللسانية ومقاربتها.
من ذلك مفهوم الحركية
(cinétisme): حركية الأفكار وفق المقولات،
كمقولة الشخص ومقولة
الزمن، حيث يوجد مسار
دلاليّ يمكن أن نثبت عليه
كلَّ نقطةٍ في ذلك المسار،
وكلّ عملية "تثبيت" (saisie) تولّدُ
"أثرا معنويّا".
2- حدّ المشترك:
ورد في معجم لالاند الفلسفيّ،
في تعريف المشترك أنّه
"خاصّية تملكها كلمة (في
عصر معيّن) لتمثيل عدّة
أفكار مختلفة؛ تتعارض
مع polytexie، التي يستعملها اللسانيون
المعاصرون للدلّ أحيانا
على وجود عدّة مرادفات
معبّرة عن الفكرة عينها"
. وقد عاد جميل صليبا في
معجمه الفلسفيّ إلى الغزالي
ليعرّف المشترك بأنّه
"اللفظ الواحد الذي يطلق
على أشياء مختلفة بالحدّ
والحقيقة إطلاقا متساويا،
كالعين تُطلق على آلة
البصر وينبوع الماء وقُرص
الشمس، وهذه مختلفة الحدود
والحقائق" .
أمّا ميشال برودو(Michel Braudeau) فيعرّف
هذا المصطلح، في الموسوعة
الكونية الفرنسية، كما
يلي: " المشترك هو الخاصية
التي تتوفر عليها بعض
العلامات في اللسان من
قدرة على توفير أكثر من
معنى. وتتقابل الوحدات
متعددة المعنى مع الوحدات
أحادية المعنى (نحو أغلب
الألفاظ العلمية). وكثير
من الألفاظ العلمية كانت
كلمات ضمن الكلمات الجارية
في اللغة العادية، فتمّت
استعارتها لأداء استعمال
مخصوص، وبعض ظواهر المشترك
يمكن أن تبرز: فإذا كان
الرمز Cu يدلّ عند الكيميائيّ
على شيء معيّن، فإنّ كلمة
نحاس تدلّ في اللسان العاديّ،
على أكثر من المعدن المعروف،
إذ قد تدلّ على الأواني
المصنوعة من النحاس،
فضلا عن دلالات أخرى نحو
قولك فلان رأسه من نحاس،كناية
عن عناده وصعوبة مراسه
(فالمجازات تقوم بدور
كبير في المشترك ).
ومن البديهيّ أنّ اعتبار
وحدة ما مِن المشترك،
يتمّ اعتمادا على تواترها.
ولكنه يبدو من العسر بمكان
تدقيق هذه الصلة بين الأمرين.
بل إنّ العلاقة بين الجناس
والمشترك تعدّ أكثر دقّةً:
فليس من السهولة بمكان
أن نحدّد ما إذا كان ينبغي
وصف بعض الوحدات بكونها
تتوفر على معان ثانوية
كثيرة (المشترك) وأي وحدات
يجب أن نعطيها توصيفا
مختلفا (الجناس). إذا كانت
المسألة مهمّة بالنسبة
إلى اللسانيات البنيوية،
حيث تمثل المعجمية مجالا
مركزيّا، فإنّ هذا الأمر
قد تغيّر مع اللسانيات
التوليدية، حيث إنّ المعايير
المعتمدة في المعالجة
بين ما هو قائم على الجناس
وما هو قائم على المشترك
تعود إلى مفاهيم البساطة
والاقتصاد" .
ويعتبر بيار لوغوفيك
أنّ المشترك يناقض الجناس،
وذلك في سياق حديثه عن
الالتباس اللسانيّ . ويرى
ريمون بودون، في معرض
حديثه عن "المنوال" أنّه
"لمّا كان المشترك خاصية
أساسية لعلم دلالة الألسنة،
يفسّر مرونتها وإنتاجيتها
وتطورها، فإنّه علينا
أن نتخلّى عن المناويل
الجبرية الكلاسيكية التي
تقود إلى إخفاء هذه الظاهرة
أو تهميشها" . ويعتبر بول
ريكور أنّ "المشترك يمثّل
القاعدة التي تقوم على
أساسها ظاهرة نقل المعنى
المخصوصة لما ندعوه "استعارة"،
إنّ الاستعارة هي أكثر
من أن تكون وجها بيانيا،
ثمّة "ما هو استعاريّ" أساسيّ
يقود عملية تكوين الحقول
الدلالية" .
وبذلك يبدو لنا اختلاف
النظر إلى مصطلح المشترك،
بين معتبر إياه خاصية
تعدّد في المعنى تشكّل
السبب الرئيسيّ في حصول
الالتباس، وهو ما يوقع
في التداخل بين المشترك
والجناس (انظر أدناه،
فقرة : المشترك والجناس)،
وبين من يرى أنّ المشترك
مهمّ في توليد عمليات
النقل الاستعاريّ للمعنى
وتحقيق إنتاجية في اللسان،
فضلا عن تطويره وتحقيق
مرونته.
ويشير غيوم جاكيه، في
أطروحته، إلى وجود وجهتي
نظر متناقضتين للمشترك:
أولاهما تعتبره ظاهرة
مصطنعة يتخذها اللسانيون
طريقة لبيان تعدد معاني
الكلمات، وبهذا المعنى
يكون المشترك غير حاصل
في اللغة الطبيعية.
ثانيهما ترى أنّ المشترك
"ممر ضروريّ" في بلورة المعنى
بالنسبة إلى أيّ وحدة
لغوية .
3- المشترك والجناس
قبل أن نتطرّق إلى مسألة
الجناس والمشترك، نودّ
التمييز بين الالتباس
والجناس. ويجب التفريق
جيّدا بين الالتباس والتوسّع
الدلاليّ، فقولنا ركبت
وسيلة نقل، لا يمكن أن
تُحمل فيه عبارة وسيلة
نقل على الالتباس بدعوى
أنّها تنطبق على الشاحنة
والدراجة وغيرهما ممّا
نُطلِق عليه في العادة
عبارة وسيلة نقل، فهذا
التعبير يقوم على توسّع
في الدلالة لا على غموض
أو التباس. تماما كما هو
الحال مع الفعل أحبّ إذ
يمكن استعماله مع معمول
بشريّ مثلما نستعمله
مع جماد، فأنت تقول: أحبّ
أبي وتقول أيضا: أحبّ مُربَّى
السفرجل، دون أن تشعر
بالتباس في معنى الفعل
أحبّ. ويبدو أنّه توجد
دلالة عامّة مشتركة في
كلّ استعمالات العبارة
ذاتها: فقط تكون الدلالة
واسعةً جدّا أو مجرَّدة.
وكذلك نقول عندما يُصبح
التجريدُ عدَمَ تحديدٍ،
وهو ما يسميّه الفلاسفة
الإنكليز غموضا (vagueness).
أمّا المشترك فيقوم على
انتقال قوانين عامّة
نسبيا من دلالة إلى أخرى،
بما يسمح إذن بتوقُّع
التنوُّع، من ذلك أنّ
لفظة (violon) في اللسان الفرنسيّ
تدلّ مرّة على الكمان
آلةً موسيقيّةً وتدلّ
مرّة أخرى على عازف الكمان.
ولكن هل نعتبر كلمة المكتب
من الجناس أم من المجاز
المرسل؛ فهي تدلّ في الوقت
ذاته على الأثاث وعلى
الإدارة؟
يبدو أنّ ثنائية الجناس[homonymie
]والمشترك[polysémie] ثنائية تلازم
مباحث علم الدلالة بشكل
مطّرد، كيف لا وهي ثنائية
تضع تحدّيا هامّا على
علماء الدلالة إذ يتساءلون
: ما العمل أمام التشابه
بين الظاهرتين؟ وكيف
نفرّق بينهما؟ وماهي
ضروب التمييز ومعايير
التفريق بين كليهما؟
وهل ثمة تراتبية في علم
الدلالة، بحيث يمكننا
اتّباعها أو تعديلها
، فنخلّص الاستعمالات
من الوقوع في شراك إحدى
هاتين الظاهرتين، لا
سيما وقد اعترف الباحثون
بأنّ الحدود بينهما غير
دقيقة ؟
ورغم ما ذكر آنفا، فإنّ
العلاقة بين الجناس والمشترك
هي علاقة تكامل: فالكلمة
التي يشتبه علينا أمرها
فإن لم تكن في خانة المشترك
فهي في خانة الجناس والعكس
بالعكس. وتوفر لنا المعاجم
الأوروبية (نحو معجم روبير
الفرنسي، على سبيل المثال)
طريقة في تعيين ما إذا
كانت الكلمة من الجناس
أو من المشترك: إذ يوضع
مدخلان منفصلان للكلمة
التي تقوم العلاقة بين
معنييها على الجناس،
نحو كلمة (avocat) التي تدلّ:
1- على المحامي، وأصلها
لاتينيّ.
2- على ثمرة الأفوكاتو،
وأصلها إسبانيّ.
فبهذا تكون كلمة (avocat) من الجناس،
فلا وجه للربط بين معنييها
المختلفين. أمّا كلمة
(exécuter) فتدلّ على معنيين مختلفين:
1- نفّذ حكم الإعدام على
متهم.
2- عزف قطعة موسيقية.
وشتان بين المعنيين،
ولكن لا يمكن الحديث عن
اختلاف في الأصل المعجميّ
فالفعل هو نفسه. فبعض المعاجم
تجعل العلاقة بين هذين
المعنيين المختلفين علاقة
جناس صوتيّ (homophones)، وبعضها
الآخر يعتبرها قائمة
على المشترك.
ومهما يكن من أمر فإنّ
الاختلافات بين المعاجم
وبين علماء الدلالة لا
تنحصر في هذا الجانب أو
ذاك، بل تمتدّ إلى تعليل
اندراج الوحدات في نطاق
هذا المفهوم أو ذاك. ولعلّه
من الأجدى البحث في معايير
لتمييز الاختلافات والتباينات
بين المعاني. وفي هذا السياق
نقف على مقترح جاءت به
فرانسواز لابال(Françoise Labelle ) يتمثل
في اعتماد أربعة معايير
لتمييز المعاني:
* معايير تركيبية[syntaxique]
* معايير صرفية[morphologique]
* معيار الترادف[synonymie]
* المعيار التأثيلي[étymologique]
ونكتفي، في هذا السياق
بتحليل المعيار التركيبيّ:
- المعيار التركيبيّ: مردّ
هذا المعيار إلى ما يتطلبه
ورود اللفظة من سياق تركيبيّ
يفرز المعنى المحدد،
هب الجملتين:
1- وجد الأعرابيّ دابّته
الضالّة.
2- وجد الرجل على ابنه الفقيد.
إنّ وجد في الجملة الأولى
بمعنى عثر على دابته،
في حين أنّ وجد في الجملة
الثانية بمعنى حزن لوفاة
ابنه. والذي أسعفنا بهذا
التمييز بين معنيي الفعلين،
هو البنية التركيبية
للفعل وجد في كل جملة. فالفعل
وجد في الجملة الأولى
تعدّى بنفسه، ولم يحتجْ
إلى حرف جرّ يُعدّيه،
أمّا فعل وجد في الجملة
الثانية فاحتاج إلى حرف
الجرّ (على) ليتعدّى به
إلى مفعوله. فعلى هذا الأساس،
يمكن اعتبار أنّ البنية
التركيبية تساهم في تحديد
المعنى المناسب للكلمة
الواردة ضمن المشترك.
ويمكن أن نضرب مثالا آخر،
على تدخّل السياق التركيبيّ،
في تعيين دلالة الألفاظ،
لفظ: عزيز بمعنى غالٍ،
يقترن بشخص، بإنسان،
أمّا عزيز بمعنى نادر
فيتصل بشيء أي بمادة يقلّ
وجودها وربّما أُطلق
أيضا على القِيَم تجوّزا.
فعندما يرد النعت "عزيز"
بعد اسم معرفة، فإنه يدلّ
على مكانة ذلك الشخص،
نحو قولك:"أبي العزيز" وقد
جاء في القرآن في نعت النبيّ
الأكرم قوله تعالى: " لقد
جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عندتم حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف
رحيم" فقد جاء في بعض التفاسير
أنّ "عزيز" بمعنى يشقّ عليه
وقوعكم في العنَت. وفي
قراءة بعض القرّاء أنّه
يفتح الفاء في "أنفَسكم"
فتكون من النفاسة، وعلى
هذه القراءة يكون ثمة
تجانسٌ بين معنى النفاسة
ومعنى الفرادة .
ويمكن أن ننظر في تحليل
المعنى المعجميّ، انطلاقا
من الأمثلة التالية:
1- أطلقت المحكمة السجين.
2- أطلقت عقيرتها بالصياح.
3- أطلق على المحلّ اسم "الخيرات".
4- أطلق رصاصتين في الهواء.
5- أطلق رجليه للريح.
6- أطلق المعنى [أي لم يجعله
مقيّدا].
7- أطلق الناقة من عقالها
.
فهذه الجمل تشترك في كونها
جميعا تحتوي على فعل (أطلق)،
غير أنّ المعاني التي
ورد عليها هذا الفعل كانت
متعددة. ويمكن تحليل هذه
المعاني باعتماد البنية
التركيبية التي تتوفر
عليها تلك الجمل. ففي الجملة
(1) أطلق بمعنى سرّحه وأفرج
عنه، وفي الجملة (2) أطلقت
بمعنى رفعت صوتها وصاحت،
وفي الجملة (3) أطلق بمعنى
سمّى، وفي الجملة (4) أطلق
بمعنى قدح الزناد واستعمل
رصاصتين، وفي الجملة
(5) أطلق بمعنى هرب وفرّ مسرعا،
وفي الجملة (6) أطلق بمعنى
جعل المعنى مفتوحا عامّا
غير محصور بقيد، وفي الجملة
(7) أطلق بمعنى ترك للناقة
حرية التنقل. نلاحظ أنّ
معاني هذه الاستعمالات
تتقارب وتتباعد، فالجملة
(1) والجملة (7) تلتقيان في
تقارب بين المعنيين،
والفرق يتمثل في كون المفعول
في (1) عاقل [+ بشريّ] في حين
أنّه في (7) غير عاقل [- بشريّ]،
فضلا عن حيثيات الإطلاق
التي يقتضيها السياق،
فالسجين الذي يطلق سراحه
يستعيد حقوقا كان محروما
منها أثناء قضائه فترة
السجن... في حين أنّ الناقة
المطلقة تستأنف حياة
"طبيعية" بعد فترة قضتها
"أليفة" بالقوة. أمّا الجملتان
(2) و(5) فتشتركان في أنّ معنى
أطلق في كلتيهما يتعلق
بذات الشخص الفاعل، ففي
(2) الفاعل [هي] ترفع صوتها،
وكذلك في (5) الفاعل[هو] يهرب
مسرعا، فالمفعول جزء
من جسد الفاعل[الرِّجْلان]
في (5) أو متعلق من متعلقاته
[العقيرة = الصوت] في (2). وأمّا
الجملتان (3) و(6) فتشتركان
في أنّ معنى أطلق يتعلق
بمعمول مجرّد من جنس لفظيّ
[التسمية] في الجملة (3) ومن
جنس معنويّ [الدلالة] في
الجملة (6). ويمكن أن نلحق
الجملة (4) بالجملتين (1) و(7)،
على اعتبار أنّ المفعول
[الرصاصتين] قد فارق المخزن
(الإهمال) إلى الفضاء (الاستعمال)،
والفرق أنّ المفعول في
(4) زيادة على كونه غير عاقل،
ينتسب إلى فئة الأشياء
[+الجماد].
ويمكن أن نمثّل البنية
التركيبية للجمل الآنفة
على النحو التالي:
ج(1): فعل [أطلق] + فاعل [المحكمة
(+عاقل)]+ مفعول [السجين (+عاقل)]
ج(2): فعل [أطلق] + فاعل [هي(+عاقل)]
+ مفعول [عقيرتها (+جسد)] +حال
[بالصياح (+حدث)]
ج(3): فعل [أطلق] + فاعل [هو (+عاقل)]
+ مفعول2 [على المحلّ (+جماد)]
+ مفعول1 [اسم "الخيرات" (+ مجرّد)]
ج(4): فعل [أطلق] + فاعل [هو (+عاقل)]
+ مفعول [رصاصتين (+جماد)]
+ مفعول فيه [في الهواء (+ظرف)]
ج(5): فعل [أطلق] + فاعل [هو (+عاقل]
+ مفعول [رجليه (+عضو)]+ مفعول
فيه [للريح (+ظرف)]
ج(6): فعل [أطلق] + فاعل [هو (+عاقل)]
+ مفعول [المعنى (+مجرد)]
ج(7): فعل [أطلق]+ فاعل [هو (+عاقل)]
+ مفعول [الناقة (- عاقل)] + مفعول
فيه [من عقالها (+جماد)]
ليس المقصود بهذه الشكلنة
الخروج بقواعد بنيوية
متينة، لمحاصرة المشترك
تركيبيا، ولكنها محاولة
لتمثيل هذه الظاهرة تركيبيا
وعدم التوقف عند النظر
إليها بوصفها مجرد ظاهرة
معجمية محضة.
4- المقاربة اللسانية: جورج
كلايبار نموذجا
يعتبر جورج كلايبار أنّ
ظاهرة المشترك قارّة
في اللسانيات، فهي ليست
بالعرَضية وبالهامشية،
بل هي عنصر بنائيّ "حتى
في علم دلالة اللغات الطبيعية"
ولقد اعتبر بعض اللسانيين
"المشتركَ حدثا لسانيا
أساسيا وسمة شديدة الانتشار
في كلّ اللغات الطبيعية"
. وتفترض هذه النقطة اتفاقا
ما حول تعريف الظاهرة
وهو ما يمثّل المكتسب
الثاني الذي يمكن تسجيله.
ومن هذا المنطلق، نرى
أنّ إجماعا تامّا يكاد
ينعقد حول وجود:
1- تعدد في المعنى متصل بشكل
واحد.
2- معانٍ لا تبدو منفصلةً
تماما، لكن توحّدها هذه
الصلة أو تلك.
فثمّة مشترك عندما "توجد
معانٍ مختلفة لكلمة واحدة،
ولكنها معانٍ تُدرك بوصفها
متّصلة فيما بينها على
نحو من الأنحاء" غير أنّ
الاتفاق يتوقف عند هذه
الحدود. فما إن نتجاوزْ
إطارَ هذا التعريف الحدْسيّ
للمشترك، وما إنْ نحاولْ
توضيحَ ما نقصد به من المعنى
ومن المعاني المختلفة
وخاصّة ما هي صلات القرابة
التي تبرّر تشابهها والتي
تسمح بالتمييز بين المشترك
والجناس (الذي لا ينطبق
عليه الشرط الأوّل)، حتى
تختلط الأمور وتفسد،
كما لاحظ ذلك فكتوري وفوكس،
في مقدّمة كتابهما، إذ
قالا: " إنّ المشترك، مثله
في ذلك مثل كثير من المصطلحات
اللسانية، مفهوم يسهل
إدراكه إدراكا حدْسيّا،
ولكنه يبدو عصيّا على
الحدّ الجامع" .
ويبدو المشترك، حسب كلايبار،
المشكل المركزيّ في تدبُّر
المعنى، وهو شكلٌ لا يمكن
اجتنابه . إنّ السؤال: لماذا
نسمّي سا الوحدة المخصوصة
لـس؟ سؤال يكشف بوضوح
الاختلاف بين المستويين.
إذا كان سا وحدة معجمية
مثل طائر فإنّ الإجابة
(أ) هي الملائمة:
(أ) س هو سا لأنّه يكتسب سمات
(سواء كانت ضرورية أو كافية،
أو طرازية بارزة، خصوصية،
نمطية، لا يهمّ وضعها
الصحيح) تعود إلى مقولة
سا أو إلى مفهومه (قارنْ
س هو طائر لأنّه يحظى بالخصائص
التي تمتّع بها مقولة
طائر أو مفهوم طائر: أي
هو حيوان، له ريش، ذو منقار،
إلخ. ).
وإذا كان سا لفظا متعدّد
المعاني مثل عِجْل الذي
يوافق متصوّر عجل- حيوان
وعجل – لحم وعجل – جِلْد،
من حيث مقولة المعنى،
فإنّ الجواب (ب) هو الملائم:
(ب) س هو سا (أو ينتمي إلى
سا) لأنّه يحظى بسمات تتصل
بمقولة ص أو بمفهوم ص،
وص هي إحدى مقولات (أو معاني)
سا. إذا كانت وحدة مخصوصة
مثل عِجْل، مُصنَّفة،
فليس لأنّ لها سمات عامّة
لمقولة المعنى إجمالا:
ليس لها سمات عِجْل – عِجْل
الذي لا يوجد إلا بوصفه
مقولة مرجعية، بما أنّ
هذه المقولة اللسانية
التي هي عِجْل، تجمع من
حيث المبدأ بين معاني
أو مفاهيم دون تكوين واحد
منها. إذا كانت س مُرتَّبةً
بوصفها عِجْلا، فليس
لأنّها تمثّل سمات ص (عِجْل
- حيوان)، ص (عِجْل - لحْم)
أو حتى ص (عِجْل - جِلْد) .
ويبدو أنّ مثال كلايبار،
يمكن النظر إليه بشكل
أوفى تفصيلا، كما يلي:
(أ) رأيتُ عِجْلاً يرعى.
(ب) أكلتُ عِجْلاً.
(ت) جلستُ على عِجْلٍ.
فعجل في (أ) هو حيوان وفي
(ب) هو لحْم وفي (ت) هو جِلْد.
غير أنّ الملفوظيْن (ب)
و(ت) يختلفان عن الملفوظ
(أ) من جهة قيامهما على ضرب
من المجاز، هو مجاز الحذف.
فـ(أكلتُ عجلا) تعني (أكلتُ
لحمَ عجلٍ) و(جلستث على
عِجْلٍ) تعني (جلستُ على
جِلْد عِجْلٍ)، لذلك لا
يعدّ استعمال لفظ (عِجْل)
في (ب) و(ت) استعمالا قائما
على المشترك، بل هو ضرب
من المجاز يمكن اعتباره،
في سياقنا، من باب "شجاعة
العربية" – على حدّ عبارة
ابن جنّي.
وقد طرح كلايبار سؤالين
مهمّين يتصلان وثيق الصلة
بظاهرة المشترك: الأوّل:
هل ينبغي "حلْق" المعاني
المتعدّدة للّفظة الواحدة؟
والسؤال الثاني: ألا يوجد
خلط في المستويات، إليه
يُردّ حصول المشترك؟
وإجابته على السؤال الأوّل
سلبيّة. فإذا كان المشترك،
أي تلك المعاني المتعدّدة
للّفظ الواحدة، هو أثر
التثبيتات المسبقة "في
نظام اللغة"، فإنّه لا
داعيَ لأخذ شكل تخطيطيّ
أصليّ أعلى للاهتمام
بعمل المشترك. وإذا كان
مستوى التثبيتات الأولى
يقع من جهة الكلام، فإنّه
ينبغي المصادرة على معنى
سابق له يقع من جهة اللغة.
وعلى لعكس من ذلك، إذا
اتصلت هذه التثبيتات
الأولى بالنظام اللسانيّ،
جُملةً، وإذا كانت منشآتٍ
دلاليةً، بوجه من الوجوه،
فإنّه يصبح من النافل
ربْطُها بسابق تجريديّ.
إذن ينبغي فحْص الموقع
الذي يدّخره المنوال
المفحوص لظاهرة المشترك
بشكل أقرب. إنّ عبارة تثبيت
تدلّ بوضوح على أنها ظواهر
تتصل بالكلام كما يدلّ
على ذلك تحليل المستوى
الأوّل لإعادة تشكيل
المعنى في الوحدات المنتمية
إلى المشترك، فالصفة
(grand) [المعنى الحرفيّ: كبير(ة)]
في المثالين الفرنسيين
التاليين لا تدلّ على
نفس المعنى:
- Une grande chambre.
- Un grand vin.
فالصفة في الجملة الأولى
تدلّ على معنى [ الاتساع
والرحابة]، في حين أنّها
تعني الخمر القادمة من
منطقة شهيرة بإنتاجها
[أي الجودة] في الجملة الثانية.
ويشير كلايبار إلى وجاهة
محافظة القائلين بالأشكال
التخطيطية على المظلّة
التجريديّة. إذ يوجد سببان
رئيسيان يحرّكان افتراض
وجود معنى تخطيطيّ أعلى.
في مقام أوّل، الرغبة
في ردّ الاعتبار لانتماء
المعاني المشتركية. لذلك
فافتراض الأشكال التخطيطية
يتميّز بتوفير صلات التشابُه
مباشرةً: تعود المعاني
المشتركية إلى الأصل
الدلاليّ ذاته، بما أنّها
ليست سوى تشكيلات أو تثبيتات
لمعنى سابق.
إذا كان التعدد لا يتحقق
إلا بتحقق شرطين أساسيين
هما الكثرة والاختلاف
فإنّ المشترك من هذه الجهة
يمكن أن يطابق التعدّد:
إنّه التعدّد المدلوليّ
المتصل بدالّّ واحد. وإن
كان التأويل وتعدّد المعنى
مترادفين عند بعض الدارسين
، فإنّ مصطلح التأويل
لا نحتاج إليه في هذا السياق
لأنّه يرتبط بممارسة
الإنجاز الفرديّ (الكلام)
في حين أننا نعالج المشترك
الدلاليّ من زاوية النظام
(اللغة). ولعلّ ممّا يُساق،
بصدد تعريف المشترك،
الخشية من حصول مضمونه
عند تعريفه، فيصير معنى
مصطلح المشترك مندرجا
ضمن المشترك، فنقع بذلك
في الدور!
إنّ وقوع "الكلمة" على مرجع
في "الواقع" كثيرا ما يتمّ
وفق صيغة قائمة على "المشترك"
بيد أنّ هذا الحلّ يبقى
غير قادر على تفسير العلاقات
بين مختلف التوافقات
المذكورة وآليات التوارث
بين الكلمات المنتمية
إلى نفس العائلة (من ذلك
العلاقة بين رواية و كتاب).
ومن ثمة فقد اقترح بعض
اللسانيين، وهو كايزر
افتراضا يتمثل في وجودكلمة
مولّدة للوحدات في شبكة
دلالية: فعندما نطلب تفسير
كلمة (كأن ترد كلمة في نص
علينا فهمُه)، نُشغِّلُ
المُوَلِّدَ في المستوى
الأول. فنتحصّل على عُقدة
أو عُقد كثيرة (فالاسم
الكتاب توافقه عُقدة
تقع على تفريع يصدر عن
عُقدة "شيء مادّيّ"). فإذا
أدّت هذه العُقدة الدور
المطلوب فإنّ مسار التفسير
يتوقّف عند هذا الحدّ.
وإلاّ فإننا نطلب من المولِّد
أن يصنع نواة أخرى أو أكثر
(فيوفّر مثلا بعض الأعمال
التي تعامل الكتاب معاملة
الشيء: القراءة، الكتابة،
النشر...). ويتكرّر هذا المسار
حتى نصل إلى عُقدة أو عُقَد
كافية للفهم أو حتّى نستنفد
المصادر الموضوعة تحت
تصرّفنا" .
وقد ارتأى كايزر هذا الاقتراح
عندما استعرض أمثلة تتصل
بكلمة كتاب، فوجد أنها
تعبّر عن مفارقة صارخة
بين محاولة إيجاد معنى
لهذه الكلمة، معنى يكون
جامعا مانعا وبين تشتت
المعاني السياقية في
الأمثلة:
- هذا الكتاب موجود في المكتبات
الجيّدة.
- سُحب من هذا الكتاب 15 ألف
نسخة.
- ذهب زيد إلى الريف ليؤلّف
كتابا.
- آثار رواد الإصلاح بادية
في هذا الكتاب.
- مثّل هذا الكتاب فشلا
ذريعا للناشر.
- هذا الكتاب مزعج.
بعد أن عرض كلايبار افتراضَ
كايزر نَقَدَهُ معتبِرا
أنّه يحتاج – في سبيل تحقيق
ذلك – إلى إدخال منوالين
مرجعيين مختلفين للتأكد
من حقيقة "التنوع" المرجعيّ
الذي زعمه كايزر، إذ اعتبر
أنّ الأمثلة السابقة
لا تشير إلى مرجع واحد،
فهو مرّة عنصر غير محدّد
في قسم أوسع من النظائر
وأخرى، هو كيان وُجدت
عناصرُ ذلك القسم انطلاقا
منه، ومرّة ثالثة عُدَّ
الكتاب شيئا (مخطوطا،
قُرصا، إلخ.)، واعتُبر
أيضا هو الأفكار الموجودة
فيه، كما نُظر إليه من
جهة تسويقه أو من جهة قراءته.
فلعلّنا مع كلايبار سنردّ
هذه التعدّدية في مستوى
المدلولات إلى أُحادية.
فإذا نظرنا إلى المثال
الأوّل:
- هذا الكتاب موجود في كلّ
المكتبات الجيّدة.
تبيّنّا منطقيا أنّ معنى
الشيء المادّيّ لا يستقيم
استقامته مع المثال الآخر:
- هذا الكتاب متّسخٌ وممزَّقٌ.
وهو معنى لا يستقيم مع
المثال الأوّل لاستحالة
أن يوجد شيء مادّيٌّ واحد
في أماكن مختلفة، في الوقت
ذاته. ويكفي لدحض اعتراض
كايزر أن نفسّر المركّب
البدليّ (هذا الكتاب) في
المثال الأوّل على اعتبار
أنّه مرجع لقسم من الأشياء
المادّيّة أو هو مرجع
لكيان فرديّ يظهر كما
هو أو بواسطة مكوّناته
في أماكن مختلفة، في الوقت
ذاته (كالتراب مثلا، إذ
يوجد تراب في كلّ مكان
من العالم، تقريبا). ويمكننا
التحقق من هذه الوضعية
إذا جعلنا مرجع (هذا الكتاب)
لا نسخةً محدَّدةً من
كتاب ما كما في قولنا (هذا
الكتاب متّسخٌ ومُمَزَّقٌ)،
بل وُرودًا (occurrence) للكتاب مثل
"البيان والتبيين" ("البيان
والتبيين" كتاب للجاحظ)،
وهو ورود يشمل نسخا محدّدة
تحمل العنوان ذاته وتمثِّل
المحتوى نفسه.
فأقوال مثل:
- "البيان والتبيين" يُوجد
في كلّ المكتبات الجيّدة.
- هذا الكتاب، أعني "البيان
والتبيين"، يوجد في كلّ
المكتبات الجيّدة.
تصرّح بالإحالة المرجعية،
أمّا القول:
- هذا الكتاب نُسخة ممزّقةٌ
من "البيان والتبيين"
فيرسم العلاقة بين الكيان
الفرديّ وحالات وروده،
هذه العلاقة تفسّر استحالة
قول من قبيل:
؟ هذا الكتاب، وهونسخة
ممزقة من "البيان والتبيين"،
يوجد في كل المكتبات الجيّدة.
إنّ الفرق بين مرجع المركّب
البدليّ (هذا الكتاب) في
القول (هذا الكتاب متسخ
وممزق) وهو وُرود محدَّد
والقول (هذا الكتاب موجود
في كلّ المكتبات الجيّدة)
وهو كيان فرديّ يشتمل
على حالات وُرود من قبيل
"البيان والتبيين"، إنّ
الفرق بينهما يتضح كما
مرّ بنا دون أن نكون مُلزَمين
– مع ذلك – بإسناد معنيين
مختلفين للمركّب البدليّ،
بما أنّ التنظيم المرجعيّ
الذي يفرّق بين حالات
الورود والكيانات الفردية،
موجود منذ البداية ويمثل
جزءا لا يتجزأ من المحتوى
التصوّريّ أو من معنى
كلمة كتاب. ولا حاجة بنا
إلى أن نصادر على مرجع
مختلف عن مرجع (هذا الكتاب
موجود في كلّ المكتبات
الجيّدة) بالنسبة إلى
المركّب البدليّ في القول:
- سُحب من هذا الكتاب 15 ألف
نسخة.
إنّه لا يوجد تنوّع مرجعيّ
بين قول وآخر كما تبرزه
الأقوال المحتوية على
الاسم العلَم لذلك الكيان:
- "البيان والتبيين" موجود
في كلّ المكتبات الجيّدة.
- سُحب من "البيان والتبيين"
15 ألف نسخة.
إنّ إعادة فحص هذا الضرب
من الأمثلة يؤدّي بنا
إلى استخلاص استنتاجين:
1/ لا يوجد داعٍ لإحداث توسيع
دلاليّ لكلمة كتاب كي
نقف على تغيُّر مرجع المركّب
البدليّ بين القولين
(هذا الكتاب متّسخ وممزّق)
و(هذا الكتاب يوجد في كلّ
المكتبات الجيّدة). يتعلّق
الأمر بآليات مرجعية
عامّة ترتبط بالتمييز
بين النمط والوُرُود
(type / token).
2/ إنّه بإظهارنا وجود صنف
من الكيانات الفردية
تشتمل هي بدورها على حالات
وُرود بالنسبة إلى كلمة
مثل كلمة كتاب، بإمكاننا
أن نتجاوز بيُسر مشاكل
أخرى طرحها كايزر، ولكن
من منظور أحاديّ الدلالة،
نحو مشاكل إحالة الضمير
(لا تشترِ هذا الكتابَ،
فهو يملكه) والإحالة الظاهرة
وغير المباشرة واتّساع
القسم، إلخ. النقطة الأساسية
التي نحتفظ بها هي البنية
المفهومية لكلمة كتاب
في حدّ ذاتها، أي معناها،
هي التي توفّر لنا هذا
الضربَ من الكيانات.
• خاتمة
إنّ التمهيد لدراسة المشترك
في اللسانيات الحديثة
يمرّ عبر تبيّن طرائق
دراسته التقليدية لمعرفة
درجة التحديث الذي اكتسبه
هذا المبحث في العلوم
اللغوية المعاصرة. ولا
يمكن المقارنة بين النظرة
الكلاسيكية لهذا المبحث
المعجميّ في الأصل والنظرة
الحديثة التي تجعله في
صلب الدلالة وتجعل من
الاهتمام به مطلبا راهنيا
حيث تتحدث الدراسات الحديثة
عن "إمبراطورية المعنى"
عند حديثها عن المشترك،
وفي ذلك كناية عن مدى توسع
هذا الظاهرة لا فقط في
الاستعمال بل وأيضا في
الدراسة والاهتمام الأكاديميّ.
* الهوامش:
محاولات في اللسانيات:
التلفّظ
*أوزفالد ديكرو
لم يَصِرْ أخذُ التلفّظِ(énonciation)
بعين الاعتبار على نحو
منظّم، مألوفًا إلاّ
منذ مدة قصيرة قي اللسانيات
الموسومة بأنّها حديثةٌ
أو علميةٌ.
وإن كنا نستطيع ملاحظةَ
هذا التناول بعدُ في مُصَنَّفَاتِ
شارل بالّي أو هنري فراي،
فإنّ ذيوعه يعود إلى كتاب
"مسائل اللسانيات العامة"
لإميل بنفنيست(1966) إذ يحمل
قسمُه الخامسُ عنوانًا
مُوحِياً: "الإنسان في
اللسان". وتظهر أصالة هذا
التمشي جليّةً ما إنْ
نُقارنْهُ بنظريّة فرديناند
دي سوسّير(F.De Saussure ).
ولْنُمَيِّزْ من الناحية
المنهجية بين مجال الأحداث
الذي يشكّل حقلَ الملاحظة
اللسانية والنظام النظريّ
الذي ينشئه اللسانيّ،
ولنوضحْ ذلك، فسوسّير
يسمّي القابل للملاحظة"
كلاماً"(parole) ويُسمّي النظامَ
"لساناً"(langue ).
إنّ اختيار كلمة "كلام"
(وكثيرا ما يُقصد إليها
بكلمة"استعمال"( لتعنيَ
مجال الأحداث، نفهم منه
أنّ الموضوع النظريّ-
على النقيض من ذلك- يجب
ألاّ يحتويَ أيّ إشارة
إلى فعل القول. ومن ثمّة
جاءت فكرة أنّ هذا موضوع
(أي اللسان) يتألّف من سنن
مقرّر بوصفه تراسُلاً
بين الحقيقة الصوتية
و الحقيقة النفسية اللتيْن
يُعَبَّرُ بهما و يُتَوَاصَلُ
بهما. و إذا استطاع الموضوعُ
العلميُّ "اللسان" أن يقوم
بوظيفته المنهجية، وأن
يسمح-على الأقل جزئيا-
بأن يفسّر النشاط اللساني
باعتباره حدثا، فإنّ
ذلك سيتمّ في حدود أن يكون
هذا النشاطُ اللسانيُّ
استعمالَ هذا القانونِ
و استخدامَهُ ولكنّ اللسانَ
ذاتَه (أي القانون)، قد
لا يحتوي على أيّ إشارة
إلى الاستعمال إلاّ بوصفه
أداةً لا تُحيل على مختلف
استخداماتها.
إنّه تمشٍّ معكوس يسمُ
لسانياتِ التلفّظ، حتى
ولو حافظنا على التفريق
المنهجيّ بين ما هو قابل
للملاحظة- المتكوّن من
التطبيقات اللغوية- والمادّة
النظرية القائمة لتفسيره-
وهي المادّة التي يمكن
مواصلة تسميتها "لسانا"-،
فإنّنا نرى أنّ هذه المادّة
تحتوي بطريقة مركّبة،
تعيينات تخصّ عمل القول،
فهذه المادة تحتوي وصفا
عامّا و ترتيبا لمختلف
وضعيات الخطاب الممكنة
كما أنّها تحتوي تعليمات
تتعلّق بالسلوك اللسانيّ،
أي بخصوصية بعض أصناف
التأثير التي نمارسها
عند الكلام، وخصوصية
بعض الأدوار التي يمكن
أن نتّخذها لأنفسنا وأن
نُلزم الآخرين بها. وتفترض
لسانيات التلفّظ أنّ
مجموعة من الأشكال النحوية
ومن مفردات المعجم و من
الصِّيَغ ومن التراكيب،
سِمَتُها الاعتياديةُ
أنّنا باستعمالها نُنشئ
أو نُسهم في إنشاء علاقات
مخصوصة بين المتخاطبين.
وإذا كان من الممكن مجدّدا
اعتبارُ اللسانِ سَنَنًا،
فإنّ ذلك ليس في معنى أنّ
السَّنَنَ يصلُح لتسجيل
محتويات الفكر، ولكن
في معنى أنّنا نتحدّث
عن سنن التأدّب، باعتباره
قائمة من السلوكات الاجتماعية.
المصطلح
أن نقول إنّ متتاليةً
لسانيةً ينتجها باثٌّ
تشكِّل ملفوظاً، يعني
أن نقول أوّلا إنّ هذا
الملفوظ يقدِّم نفسه-
وهو ينتِجها- على أن هدفه
هو أن يقول ما هو مَقُولٌ
فيها. ولنفترضْ أنّ أحدهم
يُلقي السؤال التالي
"هل جاء زيدٌ ليرى عَمْراً؟"،
فالاسم "زيد" لا يشكّل في
حدّ ذاته ملفوظا: إذ الباثّ
لا يوافق على أن يبرّر
ذلك بِنُطْق هذه الكلمة.
فإذا نطقها فسيقول إنّه
إذ قالها إنّما فعل ذلك
ليطرح السؤال الذي طرحه
وأنّه يصرّح بأنّه ملتزمٌ
فقط بمشروعية هذا السؤال
و أهمّيته باعتباره كُلاًّ.
والمقطع "هل قَدِمَ زيد"،
معتبَرا داخل المتتالية
السابقة، لا يُشكّل هو
الآخر ملفوظا: فموضوع
العبارة الصريح ليس التثبّتَ
من قدوم زيد، ولكن هو المقصد
الذي يعلّل به قدومه. إذ
يجب أخذ المتتالية جملةً
لتركيب ملفوظ. وينضاف
إلى هذا الشرط الأول الذي
يثبت للملفوظ مدى أدنى،
شرطٌ ثانٍ يرسم له حدّا
أقصى.وإذا كنّا نستطيع
داخل متتالية ما تحديد
تعاقُب مقطعين يزعم الباثّ
أنّه يربط بكلّ منهما
مسؤوليته، فإنّنا نقول
إنّ هذه المتتاليةَ لا
تتكوّن من ملفوظ واحد
بل من ملفوظين. وقد يكون
الأمر كذلك مثلا لو كان
السؤال كما يلي "هل جاء
زيد؟" وهل لرؤية عمرو؟"
فالملفوظ- كما ضبطناه
منذ حين- هو متتالية متحقّقة
فعلا أي هو تعلّق مخصوص
لكيانات لسانية. ولنفترض
أن باثّا آخر مختلفا عن
الذي تخيّلناه أعلاه
يتحدّث في نقطة أخرى من
المكان و الزمان فيطرح
السؤال نفسه لفظةً لفظةً،
فإنّنا نقول إنّ ذلك يتعلّق
بملفوظٍ آخرَ. فاعتبار
ملفوظين تحقُّقَيْنِ
للجملة نفسها، يعني افتراضَ
أنّهما كليهما يستخدمان
البنية اللسانية ذاتها.
ومن ثم ينتج عنه أنّ ذلك
الاعتبار مستقلٌّ عما
يفهم من عبارة "بنية لسانية".
فإذا ما تمثّلنا هذه البنية
اللسانية بوصفها تعاقُبا
خطِّيًّا للكلمات ذاتها
منتظمةً في نفس الترتيب.
ولكنّ الأمر سيكون مغايرا
إذا ما أدخلنا في فكرة
البنية علاقاتٍ أكثر
تعقيدا: إذ يمكن أن نتخيَّل
أنّ متتالية الكلمات
ذاتها توافق تنظيمات
مختلفة وإذن توافق جملا
مختلفة وأن نتخيّل أن
متتاليات مختلفة تظهر
التنظيم نفسه و إذن الجملة
نفسها. هكذا فإنّ لا شيء
محال( ومن ثمّة لا شيء بديهيّ)
في القول إنّ الملفوظ:"
هل جاء زيد لذلك؟" مستعمَلا
في سياق حيث "لذلك" تعني
"ليرى عَمْراً" يحقّق الجملة
نفسها التي اتّخذها الملفوظ
مثالا أعلاه. ومن ثم نستنتج
أنّ الجُمَلَ، كياناتٌ
مجرّدةٌ، لا تنتمي للقابل
للملاحظة، ولا للمعطى
ولكنّها عناصرُ من المادّة
النظرية المؤسسة لتتأكّد
من المعطى( هي تنتمي للّسان
بالمصطلح السوسيري).
علينا أن نميّز أيضا بين
الجملة والملفوظ من جهة
والتلفّظ من جهة أخرى
فالتلفّظ هو الواقعة
التاريخية التي تنشأ
عبر ظهور الملفوظ، وبعبارة
أخرى، هو حدث إنجاز الجملة.
إذ نلاحظ الفرق بين الملفوظ
و التلفّظ، ما إن نتأمّل
التباس عبارة مثل:" أدهشتْني
رسالته": هل وجدتُ نصّ الرسالة
ذاته، مُدهشاً، أم الملفوظات
التي تتكوّن منها، وما
هي الملفوظات التي تحتوي
علامات أخّاذة؟ أم هل
إنّني اندهشتُ بسبب أنّ
تلك الرسالةَ قد كُتِبَتْ
لي كما هي و الحال أنّ كاتبها
لا يكتب لي رسائلَ في العادة
أو أنّه يبعث لي رسائل
من نوعيّة أخرى؟ ففي الحالتين
الأخيرتين ما فاجأني
هو التلفّظ لا الملفوظ
هكذا نُدرِك التلفُّظَ
بوصفه انبثاقا للملفوظ،
على أنْ لا نخلط بين التلفّظ
و النشاط اللساني أي مجموع
الحركات التمفصلية والسيرورة
الذهنية و حسابات النهاية
و الوسط، الذي قاد الباثّ
إلى إنتاج ملفوظه و في
حين أنّ هذا النشاط الذي
يدرسه علم النفس اللساني
السابق للملفوظ، فإنّ
التلفّظ مزامنٌ له، إنّه
وجود الملفوظ ذاته( سنبيّن
فيما بعد أنّ اللسانيات
إذا أرادت أن تشرح معنى
الملفوظات، فعليها ألاّ
تتجاهل التلفّظ).
فالتفريق بين الملفوظ
و الجملة، وقد أُلْقِيَ
في المجال الدلاليّ،
يتطلّب لازمةً طبيعيّةً
هو التفريقُ بين القيمة
الدلالية المسندة إلى
الملفوظ( و نُسمّيها،
اعتباطا، معنى) والقيمة
الدلالية المسندة إلى
الجملة( ونُسمّيها دلالةً)،
والفرقُ بينهما في البداية
منهجيٌّ ومن المؤكّد
أنّنا لا نحدّد هذه أو
تلك إلا بواسطة الافتراضات.
لكنّ المعنى المتعلّق
بالملفوظ، ينتمي إلى
ما يمكن ملاحظته و يشتغل
بالنسبة إلى اللساني
بوصفه معطى و بوصفه حدثا
يفسّر. أمّا الدلالة،
فعلى العكس من ذلك مَثَلها
في ذلك مَثَل الجملة،
مُصَادَرٌ على اعتبارها
أداةً مفسِّرة لمعنى
الملفوظ ويتمثّل تعليلها
الوحيد الممكن في الطريقة
التي بها تُسهم في توضيح
ذلك المعنى. و كون المعنى
والدلالة مختلفيْن كذلك
من جهة مضمونيهما الخاصّين
بهما، يصبح ذلك بديهيا
ما إن نلاحظْ عدمَ إمكانيةِ
إدراكٍ مسبقٍ لمعنى الملفوظ
إذا ما عرفنا فقط الجملة
المستعملة. هَبْ أنّ باثّا
قال:" حتّى زيدٌ قَدِمَ"
فمعنى ملفوظِه يحتوي
إشارةً إلى أنّ مَقْدِمَ
زَيْدٍ هي أمارة أقوى
من أمارات أخرى على نتيجة
ما (وضعية الخطاب هي التي
تحدد تلك الأمارات الأخرى
وتلك النتيجة) إذ من البديهي
أنّ الجملة ذاتها لا تمكّننا
من معرفتها انطلاقا منها.
وفوق ذلك، نرى أنّ الاختلاف
بين المعنى و الدلالة
يتعلّق بطبيعتهما ذاتها
لا بكمّية الإشارات المنقولة
وحدها. فما تقدّمه الجملة
هي معارف لفهم الملفوظ.
هكذا، ففي مثالنا، لا
تقول الجملة فقط إنّ مقدم
زيد أمارة على شيء ما- وهو
أمر بديهيّ مسبقا- إنها
تقول إنّ الباثّ يحيل
على نتيجة مخصوصة وأنّه
ينبغي على المؤوّل كي
يفهم، أن يتنبّأ بـتلك
النتيجة. فالمعنى لا يساوي
الدلالة مضافة إليها
المؤشرات الملحقة بها
إذ إنّ الدلالة تعطينا
فقط تعليمات علينا أن
نبتني انطلاقا منها المعنى
من جديد.( ما تقدم، يؤدِّي
إلى رفض المفهوم العادي
للمعنى الحرفي إذا ما
قصدنا بذلك جزءا من معنى
الملفوظ يكون ممكنَ القراءة
في الجملة بعدُ. و في الواقع
فإنّ ما تقوله الجملة
مغايرٌ جذريا لما يقوله
الملفوظ وقد لا نعرف كيف
نتواصل مع جمل لأنّ دلالتها
تقوم خاصّة على معارف
لتحديد قيمة الملفوظ
الدلالية: هذه القيمة
وحدها يمكن أن تكون موضوع
التواصل). يوجد تمييز آخر
سابق لدراسة التلفظ بين
المخاطَب ( بفتح الطاء)
والسامع، رغم أن المفهومين
كثيرا ما يختلطان و يؤخذان
باعتبارهما مجرّد بديلين
لمفهوم المتقبل العامّ.
فسامعو الملفوظ هم أولئك
الذين يلتقون على سماعه
أو بعبارة أدقّ من ذلك،
يلتقون على الإنصات إليه.فليس
من الضروري فهمُ الملفوظ
لنعلم أنّنا كنّا له سامعين:
تكفي معرفة البيئة التي
أنتج فيها. أما المخاطبون
بالمقابل، فهم أناس يعلن
الباثّ أنّه يتوجّه إليهم.
يتعلّق الأمر إذن بدور
يمنحه الباثّ إلى هذا
أو ذاك بواسطة خطابه ذاته،
بحيث إن معرفة بيئة الخطاب
البسيطة لا تكفي لتحديدهم
إذ تحديدهم جزء من فهم
الخطاب. فالمخاطب يمكنه
حتى أن يختار في حالات
قصوى ألاّ يكون سامعا،
هكذا نقول إنّ فابريكيوس(Fabricius)
هو مخاطب روسو ( ( Rousseau:"يا فابرياكوس!
ماذا رأت روحك العظيمة؟..."
دون أن يحتاج إلى عدّه
ضمن سامعيه(و هنا ضمن قرّائه)
الحقيقيين أو الوهميين.
وبالعكس- والحالة في هذه
المرة تافهة- يمكن ألاّ
يكون بعضُ السامعين مخاطَبين،
ففي مسرحية"العالمات"(لموليير)(الفصل
الثاني، المشهد السابع)
يعتني كريزال Chrysale) (بالتوجّه
إلى ابنته الوحيدة "بيليز"Bélise))
وهي التي لا يخشى جانبها،ناقدا
مزاعم النساء العِلْمية.
وعندما تأخذ زوجته الرهيبة"فيلامنت"Philaminte))
وضعيةَ السامعة، يوحي
لها بأنها ليست مقصودةً
بتلك الانتقادات. وبالمثل،
إذا ما أراد طفل أن "يحشر
أنْفَه" في محاورة بين
أبويه، فيمكنهما أن "يُرجعا
الأمور إلى نصابها" بأن
يلاحظا له أنّ"هذا لا يعنيك"
نافيين عن الطفل دورَ
المخاطَب و هذا يسمح برفض
حقّه في الردّ و إذن في
الكلام، وهو حقّ غالبا
ما يكون مرتبطا بذلك الدور.
والتمييز الذي سبق نافِعٌ
لدراسة اللسان ولدراسة
الأدب في آن. و في الواقع
تستعمل غالبية الألسنة
علامات خاصة لتعيين وظيفة
المخاطَب كما هي الحال
في اللغة العربية بالنسبة
إلى الضميرأنتَ إذا كان
أ يتوجه إلى ب بالخطاب
أمام ج، فانه يعين ب بـأنت
و ج بـهو، و هو يمكن من جهة
أخرى أن يشتم منه في هذه
الحالة أنّه عدوانيّ
من حيث كونه يُقصي ج من
المجموعة التي كوّنها
الكلام. وكما هي أيضا حال
تعدية الفعل مباشرة ( بمقابل
استعمال الظرف أمام أو
حرف الجر عن) في عبارة "سيكلم
ص" و المخاطب كذلك يستخرج
الدلالة التصريحية للوظيفة
النحوية" الندائية الدعائية"كل
من زيد و لئيم في "زيد، ماذا
هناك؟" و "أين خُفِّي يا
لئيمُ؟" ( لا يؤدّي مركّب
يا لئيمُ ، تعجُّباً خالصًا
الوظيفة ذاتها بالضرورة)
فضلا عن أن النظرية الأدبية
تلتزم بوصف الوسائل التي
يستعملها المؤلف لتحويل
قارئ الكتاب أو مشاهد
المسرحية إلى مخاطبه
و ذلك باستدعاء تلك المحسّنات
مباشرة- أو بالمقابل ليذكر
أنّه (أي المؤوّل) لا يريد
إعطاءه ( أي القارئ أو المشاهد)
ذلك الدور، متّجها به
نحو شخص آخر.
كما تلزمنا أيضا أربعة
أزواج من المفاهيم على
الأول: المقابلة بين المتلفظ
و الباث والمقابلة الموازية
بين الملتقّى والمخاطب.
و ضرورة هاتين المقابلتين
تتّصل بإمكانية دائمة
يوفّرها اللسان و تستثمر
في الخطاب دون انقطاع
هي إمكانية "إعطاء الكلمة"
لأشخاص آخرين غير الذي
ينتج الملفوظ فعلا وهو
الذي نحتفظ له باسم الباث.
هَبْ أنّ أ باثّ يتّجه
إلى ب مخاطب بملفوظ م يسمى"
متلفظا" الشخص الذي يسند
إليه أ مسؤولية ما هو مقول
في م، ونسمّي "متلقّيا"
الشخص الذي قيل له، حسب
رأيه ما هو مقول في م. وفي
حالة ( هي الأبسط و لكنّها
ليست الأكثر تواترا) خطاب
غير مباعد بين أطرافه
إذ المتلفظ هو الباثّ
و المتلقّي هو المخاطب
و بالمقابل فإنّه عندما
ينقل الكلام المقول،
فإنّ المتلفظ يمكن أن
يكون الباثّ أو شخصا ثالثا
أيضا.
من الأمثلة على ذلك أنه
قد يرد أنّ الباثّ نفسه
يطرح أسئلة يرغب أو يرى
أنّه يتعيّن عليه الإجابة
عنها. هكذا لاحظ علماء
النفس ميل بعض الأطفال
يريدون أن يحيطوا آباءهم
علما بأنّهم أتمّوا بعض
الأعمال الفاضلة، إلى
جعل آبائهم "كما لو" أنّهم
هم الذين يطلبون حكاية
تلك الأعمال كطفل يقول
عند الجلوس إلى مائدة
الطعام:"أمّي، ماذا كنتُ
أفعل منذ حين؟ لقد كنتُ
أغسلُ يديَّ !"
فالأمّ مخاطبةٌ بالملفوظ
الاستفهامي و الشاهد
على ذلك المنادى أُمِّي،
أمّا الطفل فهو الباثّ
بما أنّ ضمير المتكلّم
يعود عليه. و لكنّه يقدّم
أمّه وكأنّها تطرح عليه
سؤالا:"ماذا كنتَ تفعل؟"
فالمخاطبة إذن في خطاب
الطفل، متلفظة بالملفوظ
الأوّل [الضمنيّ]و الطفلُ
الباثُّ متلقّيه. تبادل
الأدوار ذاته يسمح بوصف
خطاب يحسّ أ فيه بأنّ ب
يندهش لحضوره، فيقول
له:"لماذا أنا هنا؟ لأنّ
ذلك يسرّني". فباثّ السؤال
هو متلقّيه، و المخاطب
هو المتلفّظ به. و تستعمل
الوسيلة نفسها في الخطاب
الجامعي إذ يطرح المؤلّف
( سلسلة من الأسئلة مُعلنا
المراحل الأساسية لتمشّيه،
أي يُظهِِِِِر طرحها
على لسان قارئ مُهتمّ-
إذن وهميّ- يقترب هكذا
من منزلة المتلفّظ. فضلا
عن أنّ المعنى المزدوج
لكلمة سؤال ذو دلالة من
زاوية النظر هذه: إذ نتناول
سؤالا معتبرا موضوعَ
خطاب و لكننا أيضا نطرح
سؤالا باعتباره استفهاما.
ولكن أليس الموضوع الذي
يتكلّم فيه أحدهم، شيئا
آخر للظاهرة نفسها- أكثر
من جهة كون خطابات مختلف
المتخاطبين أشدّ تشابُكا.
وتحرّضنا أسبابٌ شتّى
على فهم كثير من الملفوظات
المنفيّة باعتبارها دحضا
للملفوظات المثبتة المقابلة
المنسوبة إلى متلفّظ
خياليّ. وهذه حالة البنى
المتكرّرة نحو"ليس فرنسيّا
بل هو بلجيكيّ". فملاحظة
شروط استعمال هذه البنى،
تبيّن أنّه ينبغي لاستعمالها
أن يكون شخص ما قادرا على
إثباتِ ما يقع أو نَفْيِهِ.
هكذا يمثّل الملفوظ المأخوذُ
في المثال ضرباً من الحوار
المبلْوَر حيث يُثبت
متلفّظ مختلف عن الباثّ
أنّ أحدَهم فرنسيٌّ ويُناقض
كلامَه ويصوّبه متلفّظ
ثان(مماثل في هذه المرّة
للباثّ). و يكون هذا التأويل
أشدّ إلزاما من ذلك إذا
أُدخل التصحيح [وهو ما
نسمّيه الإضراب في النحو
العربيّ-المترجم-] بواسطة
المركّب بالعكس:
"لم يسافر زيدٌ بل بالعكس
لقد قال لي إنّه لن يتحرّك
هذا الأسبوع".
فالملفوظ الثاني يقدّم
نفسه على أنّه نقيضُ شيء
ما، ولكنّه نقيض ماذا؟
ليس نقيض المحتوى العامّ
للملفوظ الأوّل الذي
هو مُؤيّد في الواقع. فإذا
ما كان ثمّة تضارُب، فمع
الإثبات المنفيّ في الملفوظ
الأوّل الذي يحافظ إذن
على ضرب من الحضور رغم
النفي الذي تعرّض له ذلك
الضرب. هناك أيضا، تُفسَّر
الأحداث جيّداً إذا ما
وصفنا الملفوظ المنفيّ
باعتباره محتويا إثباتا
في الوقت نفسه بحيث يكون
المتلفّظ إمّا مخاطَبا
أو شخصا ثالثا فضلا عن"لا"
يُجيب بها الباث-المتلفظ.
ففكرة أنّ إثباتا مبطّنا
في الملفوظ المنفيّ مُعلّلة
من الناحية اللسانية
وهي إلى ذلك مضيئة من الناحية
النفسية. و لمعرفة ذلك
لا نحتاج إلى أن نؤكّد
مع فرويد(Freud) أنّ ذلك الإثبات
يُكوّن حقيقة الملفوظ
كما يعبّر عن رغبة اللاوعي
و أنّ النفي شرط سطحيّ
مفروض من قبل الرقابة
لتمرير الإثبات. يكفي
أن نبحث-حتى و نحن متعلّقون
بالسطح- عن تفسير الطريقة
التي بها تترابط الملفوظات
في الخطاب. وسنرى غالبا
النفي لا أ يتبع مسارا
بموجب بعض مبادئ "الفِطرة
السليمة"، يمكنه أن يصل
إلى النتيجة أ . ففي قصيدة
فرجيل((Virgile الرَّعَوِيَّة
الأولى يقول ميليبي(Mélibée)
و قد قارن حظّه النحس بهناء
صديقه تيتير((Tityre، مضيفا:
"لست أحسده على أيّ شيء"
فكي نعطيَ خطابَ ميليبي
انسجاما داخليا، ينبغي
التسليم بأنّ النفي هنا
يُفنّد النتيجة التالية"الغالب
على الظنّ أنّك حَسود"
ينسبها ميليبي إلى مخاطبه
تيتير.
فالأمثلة السابقة تبيّن
أنّ إمكانية جعل الآخر
يتكلم في خطابنا الخاصّ
تتجاوز مجال ما نسميه
عادة "الخطاب المنقول".
ولكنها لا تغطّي كل ذلك
المجال. هبْ، في الواقع
أنّ باثا أ يريد إعلام
مخاطبه بأقوال تلفظ بها
ب. سيقول في الأسلوب المباشر:
"قالب: انخفضت البطالة"
أو في الأسلوب غير المباشر
الموصول "قالب إنّ البطالة
انخفضت" ففي كلتا الحالتين
لا يقوم ب داخل خطاب أ بدور
المتلفظ.و الإثبات الوحيد
المنجز موضوعه أقوالب
السابقة فـأهو المتلفظ
بهذا الإثبات: إذ يقدّم
نفسه بوصفه مسؤولا كما
لو يتعلق الأمر بإثبات
ذوق ب أو جواربه. و لنتخيّل
الآن أنّ أ يقول:"بدأت سياسة
الحكومة تؤتي أكلها: حسب
ب ستنخفض البطالة" فليس
موضوع الخطاب هنا كلام
ب (لأننا لا يمكن أن نستنتج
شيئا من هذا الكلام الذي
قد يكون خاطئا) و لكنه الوضعية
الاقتصادية. فـأ يرجع
إلى انخفاض البطالة ويستنتج
منه نجاح الحكومة. ببساطة
لا يريد إن يأخذ على عاتقه
أمر إثبات أنّ البطالة
انخفضت و عمد إلى إعلان
ذلك على لسان ب. إذ يتعلّق
الأمر بخطاب عن الحقيقة
لا عن الكلام و لكنّه خطاب
أعطيَ الكلام فيه لمتلفّظ
مختلف عن الباثّ.
ففي هذه الظروف فقط، يتضمّن
الخطاب المنقول تغيّر
المتلفظ و يُظهر تعددية
الأصوات المختلفة يحملها
باث واحد. والسمة الخاصة
بهذه الوضعية هي أنّ هدف
الكلام المُعلَنَ ليس
نقل الكلمات إذ تقرير
الكلمات مُدمَجٌ في الخطاب
عن الأشياء. و سبُل السلطة
و التهكّم و التنازل هي
صور من هذه الوسيلة متواترة
بطريقة خاصة.فالسلطة
نحو "كما يقول أفلاطون"
أو نحو "كلنا نعلم أن..." مدرجة
في عرض حجة تسمع بالاستنتاج
انطلاقا من تلك الحجة
دون أن يكون علينا البرهنة
على صحتها-كما انه لا نطلقها
من عندنا بل على لسان أفلاطون
أو "كلنا". و يجري التهكّم
بالطريقة ذاتها ولكن
في اتجاه معاكس. فلبيان
خطأ أطروحة نستعمل حججا
لا معقولة على حسابها
مسندة إلى المدافعين
عن تلك الأطروحة. والتنازل
يدخل أيضا في الترسيمة
ذاتها. إذ الملفوظ التنازلي
المسبوق بـ مع أن أو المتبوع
بـ لكن، غالبا ما يكون
لخصم حقيقي أو خيالي نعطي
إليه الكلمة ونسمح له
ولو للحظة بالمحاجة بمعنى
مضاد للذي نريد استنتاجه.
ويمكننا إذن حسب استراتيجية
أساسية في الليبرالية
أن نقدّم الحقّ المعروف
للآخر في الكلام بوصفه
مقوّيا للنتيجة التي
بواسطتها نتضادُّ معه،
فهي تظهر له بالأحرى" موضوعيةّ"
حتّى أنّها لم تخش مواجهة
وجهة نظر الخصم. وإذا تمكّنت
كلّ هذه الروابط البيذاتية
من التحقّق في النشاط
اللساني، فإنّ التلفّظ
لا يتطابق مع مجرّد بثّ
للأقوال إذ يمكن للباثّ
أن يسلّم للمخاطب أو لشخص
ثالث مكان المتلفّظ ويأخذ
مكان المتلقّي.
معنى الملفوظ باعتباره
وصفا للتلفّظ
بالنظر عبر المصطلحية
التي كنّا بصدد اقتراحها،
يصلح مفهومُ التلفّظ
في الوقت ذاته لوصف معنى
الملفوظات(مُعتبراً حَدَثا،
مُعطًى للتفسير) ولتثبيت
دلالة الجُمَل(أي الموضوع
الذي بواسطته يفسّر اللّسانيّ
المعنى). في خصوص النقطة
الأولى، يمكن لنا أن نعرّف
معنى الملفوظ(دون أن يكون
التعريف المقترح، هو
الوحيد للمكن) باعتباره
وصفا لتلفّظه: قد يكون
ضربا من الدور يضعه الباثّ
للمخاطب، يَسم به الحدَث
التاريخي الذي يمثّله
ظهور الملفوظ.
في صلب هذا التعريف توجد
فكرة أنّ الباثّ حتى في
الملفوظات الأكثر"موضوعية"
في الظاهر يتحدّث عن التلفّظ.
تاريخيّا يجب أن نربط
مثل هذه الأطروحة بأبحاث
بنفنيست(Benveniste ) عن الضمائر(مسائل
اللسانيات العامة، الجزء
الأول، الفصل العشرون)
حتى و إن انتهت إلى وضعها
موضع شكّ.
يرتكز بنفنيست على أمر
متعارَف عليه وهو أنّ
ضمائر المتكلّم و المخاطَب
تصلح على التوالي لتحديد
الكائن الذي هو بصدد الكلام
و الكائن الذي يُكلَّم.
و ينتج عن ذلك أنّنا باستعمالنا
أحدَ الضمائر إنّما نُحيل
دائما على كلامه الخاصّ
بإلحاح من الخطاب الذي
اُستُعمِل الضمير في
نطاقه.
و اللحظة العسيرة في منطق
بنفنيست هي تلك التي انطلاقا
من ذلك الحدث و أخذا في
الاعتبار أنّه توجد ضمائر
المتكلّم و المخاطب في
كل الألسنة المعروفة،
يستنتج أن الإشارة إلى
بداية الخطاب سمةٌ جوهرية
أساسية للكلام البشري.
وهو استنتاج لا يُحتاج
إليه إذا فهمنا من "سمة
جوهرية"، أنّ المضامين
التي يتواصل عبرها الكلام،
قد جعلتْها سمة ضرورية.
و في الواقع نستطيع دائما
أن نجيب بأنّ الاستعانة
بـأنا و أنتَ لتعيين كائنات
مخصوصة هي مجرّد وسيلة
تفسّر كونيّتها فقط بميزتها
الاقتصادية.
في قلب هذا التعريف توجد
فكرة كون الباث، حتى في
الملفوظات الأكثر "موضوعية"
في الظاهر، يتحدث عن التلف.
تاريخيا يجب أن نربط مثل
هذه الأطروحة بأبحاث
بنفنيست عن الضمائر(مسائل
اللسانيات العامة، الجزء
الأول، الفصل العشرون)،
حتى وإن انتهت إلى وضعها
موضع شكّ.
يرتكز بنفنيست على أمر
متعارف عليه و هو أن ضمائر
المتكلّم و المخاطب تصلح
على التوالي لتحديد الكائن
الذي هو بصدد الكلام و
الكائن الذي يُكَلَّمُ.
و ينتج عن ذلك أننا باستعمالنا
أحد الضمائر إنمّا نحيل
دائما على كلامه الخاصّ
بإلحاح من الخطاب الذي
استُعمل الضمير في نطاقه.
و اللحظة العسيرة في تفكير
بنفنيست هي تلك التي،
يستنتج فيها أنّ الإشارة
من البداية إلى الخطاب
سمة جوهرية أساسية للكلام
البشري انطلاقا من ذلك
الحدث و أخذا في الاعتبار
أنّه توجد ضمائر المتكلّم
و المخاطب في كل الألسنة
المعروفة. و هو استنتاج
لا يحتاج إليه إذا فهمنا
من عبارة "سمة جوهرية" أنّ
المضامين التي يتواصل
عبرها الكلام قد جعلتها
سمةً ضروريةً. و في الواقع
نستطيع دائما أن نجيب
بأنّ الاستعانة بـأنا
و أنت لتعيين كائنات مخصوصة،
هي مجرّد وسيلة، تفسر
كونيتها فقط بميزتها
الاقتصادية. ولنبيّن
ذلك، يكفي تخيل لسان بلا
أنا و أنت وترجمة كل المعلومات
المتلفظة بـأنا و أنت.
فجاسر لكي يقول "أنا حزين"
عليه أن يقول" جاسر حزين
و لكي يقول "اسمي جاسر" عليه
أن يقول "الشخص الماثل
في مكان كذا ساعة كذا اسمه
جاسر". فإذا ما أردنا المحافظة
على استنتاج بنفنيست
الذي بموجبه تكون الإحالة
في بداية الخطاب جوهرية
في الكلام، علينا أن نصلها
عن حجاجه، وعلينا ألا
ترتكز على الوظيفة المرجعية
للكلمات المخصوصة (ضمائر
أن عناصر اشارية مثل هنا
والآن)، لأن الإحالات
نفسها يمكن دائما و عند
الاقتضاء أن تحصل دون
تلك الكلمات. و بصفة أعمّ
إذا كانت الإحالة على
التلف مكونة معنى الملفوظ،
فليس ذلك لأن هذا لا المعنى
يحتوي إشارات يستحيل
التواصل في شأنها بوجه
آخر إلا بالنسبة إلى الوضعية
التي نتكلّم فيها. و للدفاع
عن أطروحة بنفنيست، ينبغي
الاحتفاظ بأنّ المعنى
نفسه يتمثل في وصف للتلفظ:
فالإشارة التي يقوم بها
له تتعلق إذن بما يتكلّم
به عنه، ولا يتعلّق الأمر
بهذا الاعتبار بوسيلة
بل بضرورة.
نقف على حجّة أولى في اعتبار
ما يسمّيه فلاسفة اللغة
بعد ج.ل. أوستن "أعمالا لاقولية".
بين الأعمال التي نبحث
عن إتمامها بإنتاج ملفوظ،
يفرق أوستن بين الأعمال
اللاقولية (الاستفهام،
الإثبات، الأمر، الوعد...)وأعمال
قصد القول ( المؤاساة،
التعيير، الحمل على الاعتقاد...)
فالأولى تختصّ بسمة أساسية
تتمثل في أن المتلفظ لا
يمكنه إتمام ذلك العمل
إلاّ بمحاولة إحاطة المتلقّي
علما بأنّه يتمّه في حين
أننا يمكن أن نواسيَ أحدا
و نحن نخفي ذلك، فإننا
لا نعلم كيف نستفهمه أو
نأمره دون أن نسعى في الوقت
نفسه إلى أن نعلمه بأنّه
موضوع استفهام أو أمر.
فسمة هذه الأعمال "المفتوحة"
أساسا وصلتها الضرورية
بتواصلها الخاص، تعسران
عدم اعتبارهما قسما مندمجا
في معنى الملفوظات، بواسطتهما
تصنع الملفوظات. على أنه
قد يرد أن إتمام عمل لا
قولي –وهذه سمة ثانية-
يحتوي بالضرورة تأهيلا
للتلفظ. فإلقاء أمر، هو
الزعم من جهة أن المتلقي
مُجبَر على القيام بعمل
ما، وهو الزعم من جهة أخرى
أنه مجبر تبعا للتلفظ
الناقل لذلك الأمر.فالمتلفظ
إذ يأمر أحدهم بالمجيء،
إنما يسند لكلامه الخاص
القدرة على اختراع إجبار
لمتلقيه لم يكن من قبل.
والأمر ذاته ينطبق على
السؤال، فطرح سؤال"ماذا
فعلت؟" على أحدهم، وسم
الحدث حتى و قد أنشأه إنتاج
هذه الكلمات بوصفه مجبر
للمتلقي على ضرب معين
من السلوك اللساني (وبالتعالق،
أن يقول ماذا فعل) يبين
هذان المثالان ما يقتضيه
الافتراض العسير التجنب،
والذي بمقتضاه يكون كل
كلام أمرا، سؤالا..الخ.منتميا
إلى معنى الملفوظ و يقتضي
هذا الافتراض أن نعتبر
أن تأهيل الحدث باعتباره
خالق اجبارات، أي بوصفه
منتجا تحول قضائي لوضعية
المتخاطبين.
ولننظر كيف أن تأهيل التلفظ
منشئ للمعنى، يمكن لنا
بالتوازي أن نضع في الاعتبار
ما يسميه ج.س. أنسكمبر وأ.
ديكرو "حجاجا". فعدد كبير
من الملفوظات لا يمكن
فهمها إلا بمعرفة مقصد
المتلفظ المفتوح لحمل
متلقيه إلى ضرب معين من
الاستنتاجات.
فلنقارن مثلا الملفوظين
)1) أكل زيد قليلا.
(2) زيد قليل الأكل.
فهما لا يتمايزان عن بعضهما
بعضا بالمعلومات التي
يعطيانها و الإمكانية
الوحيدة لمقابلتهما تتمثل
في تسجيل أنهما لا يمكن
أن يقدما لصالح النتيجة
نفسها إذ المتلفظ الذي
يستعمل الملفوظ الأول
في مقصد معلن لحث متقبله
على أن يطعم زيدا، يعتبر
الملفوظ الثاني بالعكس
يوحي محرضا على عدم دعوته
للطعام: بحيث أن عليه أن
يعمد إلى لكن لكي يستعمل
الملفوظ الثاني ويوحي
بدعوة مفتوحة معا فيقول:"زيد
قليل الأكل و لكن أدعه
مع ذلك". فإذا ما سلمنا إذن
بأنّ الملفوظ(1) والملفوظ(2)
منتجين في الوضعية نفسها،
لهما معان مختلفة، فانه
يبدو من العسير عدم اعتبار
القصد الحِجاجي منشئا
للمعنى. و حتى يتمكن هذا
الاستنتاج من أن يخدم
الأطروحة المدافع عنها
هنا والتي بموجبها يكون
المعنى توصينا للمتلفظ،
علينا الآن أن ندقق الأمر
المقصد الحجاجي الذي
نحن بصدده إذ هو ليس بالضرورة
ذاك الذي يقود التلفظ
في الواقع: بل هو معطى،
مقدم بوصفه موجها. فمن
الممكن جدا استعمال(1) و
(2) في معنى نفسه، مثلا ليدعو
المخاطب ( الذي نفترض أننا
حددنا هويته مع المتلقي)
زيدا للطعام إشفاقا عليه
لأنه لم يأكل كثيرا. لكن
استعمال (2) يجعل الهدف المطموح
إليه، وفي حل للمناورة
و التجربة: فبـ(2) "نوهم" بأننا
لا نبحث عن الدعوة. فما
يميز بين (1) و (2) هو إذن المسعى
الحجاجي المسند إلى التلفظ،
فقط لا غير حسبما نعمد
إلى أحد أو غيره، نصف المتلفظ
باعتباره آيلا إلى ممارسة
تأثيرات متناقضة. مما
يِؤدّي بنا إلى استنتاج
أن الملفوظ الحجاجي ( وأغلبية
الملفوظات حجاجية)
يتحدث عن تلفّظه الخاصّ
كان مصرّحا بالمفعول
الذي يبحث عن استخراجه
و تنتمي بعض الكلمات إلى
صنف من الظواهر فيه ينكشف
أيضا كيف يخصّص المعنى
الحدث المنشأ عبر التلفّظ.
يمكن أن نبيّن أن عددا
كبيرا من ملفوظاتنا ضمنيا
تمثلا لشخصيات التلفظ
الابتدائية: الباث و المخاطب.
وهذا ما يحدث مثلا، فيما
يتعلق بالمخاطب كلما
لأعطي دور المتلفظ و كلما
جعلناه يتكلم. فإذا ما
سلكنا بأن الملفوظات
المنفية تضع متلفظا يثبت
ما هو منفي. فضلا عن ذلك
إذا ما سلمنا غالبا بأن
ذلك المتلفظ يحدده المخاطب،
فانه علينا إن نستخلص
في هذه الحالات أن معنى
الملفوظ يحتوي صورة المخاطب
مقدما بوصفه إنسانا من
شأنه أن يؤكد ما ينفيه
الباث. و استعمال مركب
مثل بما أن له مفعول مشابه.
فقولك: بما أن أ، فانّ،
ب يضع متلفظا يقوم بالعمل
اللاقولي الذي حدده أ
الذي يرتكز لذلك على أن
متلقيه نفسه أكد القضية
المؤكدة في ب أو هو جاهز
لتأكيدها. إنّ الملفوظ:"بما
أنّ الطقس جميلٌ، فلْتخرجْ"
يمثّل هكذا متلفظا ينصح
المتلقي بالخروج مؤسسا
هذا الأمر على أنّ المتلقي
زعم أو علم أنّ الطقس جميل،
قضيةً يمكن للمتلفظ ألاّ
يأخذها في اعتباره الخاص.(لاحظْ
أنّ الأمر لا يكون على
هذه الشاكلة إذا ما عوّضنا
بما أنّ بـلأنّ: فسيظهر
الطقس الجميل بوصفه ملفوظا
لمتلقّ هو نفسه يشكّ فيه
أو لم يفكّرْ فيه.) النتيجة
أنّه في حالة الخطاب غير
المتباعد العناصر حيث
نحدّد من جهة الباثَّ
و المتلفظَ، ومن جهة أخرى
المخاطبَ والمتلقّيَ،
فانّ استعمال بما أنّ
يقتضي تمثلا معيّنا لأقوال
الشخص الذي نتوجّه إليه(المخاطب)
و اعتقاداته.
سنلاحظ أنّ تمثُّلَ الآخر
و بطريقة أعمّ أنّ صورةَ
التلفظ المسيّرة في معنى
الملفوظ ليسا مثبتيْن
بأتمّ معنى الكلمة و لكنهما
بالأحرى مؤدّيان(بمعنى
أنّ الممثل المسرحي لا
يثبت الأحداث الممثلة
في المسرحية ولكنّه يؤدّيها،
أي انه يعطيها حقيقتَها
بحضوره نفسِه).ر فإذا سلّمنا
بتصوّر للمعنى كنا بصدد
تقديمه، فإنّ مفهوم الإثبات
والتأكيد لا يمكن أن يصلح
لتعريف العلاقة بين الملفوظ
و معناه. فلا ينبغي أن يُعتبَر
الملفوظ وسيلةً لتأكيد
حقيقة ما: فالأولى أن نقولَ
انّه يظهر ذلك المعنى.
في حين يصبح الإثبات من
هذا المنظور داخلا في
المعنى. فهو يُكوّنُ عملا
لاقوليا بين أعمال أخرى
أي تخصيصا للتلفظ المقدَّم
بوصفه يخلق للمتلقي حملا
على الاعتقاد. لكن المعنى
ذاته أي أن يكون التلفظ-ضمن
أشياء أخرى، وبطريقة
عرَضية- تأكيد فكرة أو
أخرى، هذا المعنى ذاته
ليس مؤكّدا: لقد أقام الملفوظ
عليه برهنةً.
تسجيل التلفظ في اللسان
فعلى اللسانيات-كما كنا
نبيّن-أن تُعنى بالتلفظ
بحيث أنه عليها أن تعطيَ
وسيلة تقديم معنى الملفوظات.
و لكن عليها كذلك أن تسمح
بتفسير ذلك المعنى بالاستناد
إلى دلالة الجمل و إلى
ظروف الكلام.
و الحالة هذه، فإنّه توجد
بواعث على التسليم كذلك
في مجموعة التعليمات-هذه
التي تمثّل دلالة جمل
التلميحات إلى تلفّظها
المضمر- (التسليم) بما يمكن
أن نعبّر عنه بقولنا إنّ
التلفظ مأخوذ على عاتق
اللسان.
سنجعل مثالا أوّل لدراسة
الظروف (adverbes ) إذ نعلم أنّ
بعض الظروف أو
التراكيب الظرفية يمكنها
بخلاف غيرها أن تستند
إلى عمل لاقولي منجز بواسطة
ذلك الملفوظ الذي تظهر
فيه. و هذا ما يحدث خصوصا
إذا ما وضعنا في صدارة
الجملة تراكيبَ مثل: بصدق،
مهما حدث، بكل النزاهة،
سرّيّا، باختصار. فبإضافة
إحدى هذه العبارات أمام:
قولك هذا المطعم ممتاز،
فإننا لا نخصّص كونَ المطعم
ممتازا و لكن الإثبات
الذي نقوم به لذلك الامتياز،
إثبات نقول إنّه صريح،
أو مرتجل أو نزيه أو سرّيّ،
أو مقدّم في شكل ملخّص.
مثل تلك الاستعمالات
الظرفية تشارك في تقييم
التلفظ المضمر بعدُ(انظرْ
أعلاه) عن طريق إنجاز الأعمال
القولية كالإثبات. و الحال
أنه يجب أن نلاحظ فضلا
عن ذلك، أنّ كل تركيب ظرفي
لا يحتمل هذه الوظيفة-
حتى ولو كان من الناحية
الدلالية قريبا جدّا
من التراكيب السابقة-
فهذه لا يمكن أن تعوّض
مثلا في الدور الذي أسندناه
إليها بـ:بمصداقية، صدفةً،
بطريقة نزيهة، بطريقة
عجيبة، بطريقة مختصرة.
و بالتالي نستنتج أنّ
إمكانية استعمال تلفظي
للظروف ليست مسقطةً على
اللسان، بل هي مقدّرة
في التنظيم النحوي الداخلي.
و حتى و نحن نعطي لكلمة"لسان"
معناها الأضيق، فإننا
مجبورون لوصفه أن نصف
بعض عناصره باعتبارها
محمولات ممكنة للتلفظ.
ونحن مسوقون إلى النتيجة
نفسها إذا ما اعتبرنا
وجود أواليات تعجبية
في كثير من الألسنة (وربما
في كل الألسنة). قد يتعلّق
الأمر بصيغ إعرابية كالتي
تسمح مثلا بإعطاء إثبات
أن س لطيف جدا صبغة "ذاتية"
أو"تعبيرية" وذلك بتشكيلها
على نحو:" كم س لطيف ؟"، " سعلى
قدر من اللطافة كبير؟"،
"س في غاية اللطف؟"...كيف نصف
المفعول الدلالي لمثل
هذه الصيغ؟
من الثابت أنها لا تصلح
لتدل على"درجة من اللطافة"
قد تكون مختلفة عن تلك
الموسومة بـجدّا. فما
تصلح له هذه الصيغ بالأحرى
هو أنها تنشئ صورة للتلفظ
تظهر بفضلها " منتزعة" من
المتلفظ لِما وقر في نفسه
من إعجاب بلطف س كأنه يدفعه
إلى الحديث عنه، فالكلام
متخذا مظهرا شبه اضطراري
وقد أثاره شعور إنما يقره
لك من كونه يصرح به.
فضلا عن هذه التراكيب
التعجبية المصحوبة بخصائص
إعرابية دقيقة فالألسنة
تملك أيضا لتملأ الوظيفة
التعجبية كلمات مخصوصة
هي أسماء الأفعال و أصوات
التعجب: آه ! أوه ! أواه ! وا
حسرتي !...التي تكون جزءا
هاما من كل محادثة، تصلح
هي أيضا لتوثيق الكلام:
عند تنطق بها نأخذ نفسا
بحيث لا نقدر سوى على النطق
بها. و هي دائما الوظيفة
نفسها التي تعوضها التنغيمات:"حركات
الكلام" تلك: فإبداء الازدراء
بتنغيم بدل التصريح السافر"
أَزْدَرِيكَ" هو إظهار
أننا كما لو كنّا نبدأ
ذلك غير مختارين، كما
لو أننا تركناه فقط وحده
يُبدي مشاعره، كما لو
أنه يفيض من القلب على
الشفتين. هكذا فإنّ مكوّنات
اللسان الأساسية الثلاثة:
الإعراب، المعجم، الصوتيات
تحتوي وسائل خاصة تسمح
للباث، داخل الملفوظ،
أن يصف تلفظه بكونه ضروريا
غير اعتباطي- بمالا يمنع
أن تكون هذه الوسائل كغيرها
من الكيانات اللسانية
شديدة الاعتباطية.
ويوجد مثال أخير خاص بصنف
من الظواهر شديد الاختلاف،
لكنه يدلّ هو الآخر على
أنّ التسجيل في اللسان
من الحدث العامّ للتلفظ.
فعلامات التلفظ التي
أشرنا إليها حتى الآن
هي كيانات لسانية معتبرة
معزولة عن بعضها بعضا(كلمات،
تراكيب نحوية، تنغيمات)
و سنُعنى الآن بالصلات
بين الكيانات اللسانية-
و بالتدقيق بصلة مخصوصة:
الاشتقاق النحتي الصياغي(délocutivité)
(مفهوم ابتدعه إميل بنفنيست
في الفصل الثالث و العشرين
من الجزء الأوّل من كتابه
"مسائل اللسانيات العامة").
فأن نقول بصفة عامة إن
العلامة ع2 مشتقّة من العلامة
ع1 يعني من جهة أنه يوجد
تشابه (و ربما تطابق) بين
الدالّيْن ط1 و ط2، ومن جهة
أخرى العزم على استدعاء
ع1 في الوصف الذي نعطيه
من المدلول ت2 لـع2، لكن
العكس غير صحيح. هكذا فالقول
إن مُنيْزِل ع2 مشتق من
منزل ع1 ، يعني العزم على
تمثيل المدلول ت2 لمنيزل
بالنسبة إلى مدلول منزل
بوصفه "منزلا صغيرا"، مع
رفض تمثيل منزل بوصفه"منيْزلا
كبيرا". في هذا المثال يقوم
الرابط بين 2توع1 على أنّ
ت2 يُنظر إليه باعتباره
تخصيصا للمدلول ت1 لـع1
. أحيانا أيضا فانّ الدال
ط1لـع1 هو الذي نستدعيه
في التمثيل الدلالي لـع2
. و لنأخذْ مثال الاسم الإنكليزي
(sir) باعتباره ع1 و الفعل الإنكليزي
الأمريكي (to sir) باعتباره
ع2 و نسلّم باشتقاق الثاني
من الأوّل إذا ما وصفنا
ت2 ( ولا نعلم كيف نصفه بطريقة
أخرى) باعتباره "نطقا بلفظة
sir متوجها إلى شخص ما".
رغم أنّ هذه الحالة الأخيرة
تدخل حسب بنفنيست ضمن
الاشتقاق النحتي الصياغي
فإننا نحتفظ بهذا المصطلح
لاحتمال آخر ذاك الذي
نَصِفُه ت2 بالإلماع إلى
عمل لا قولي محتمل لتخصيص
تلفظ يدخل فيه ت 2 هذا المثال
مختلف عن سابقه من جهة
كون العمل اللاقولي هو
شيء آخر مغاير تماما للنشاط
الصوتي البسيط القائم
على إرسال بعض الأصوات
بحيث إن عملا لا قوليا
يكون ممكن التحقيق بفضل
ع1 يمكنه إن يتحقق أيضا
بواسطة علامات شديدة
الاختلاف. لذلك لا يختزل
الاشتقاق النحتي الصياغي
في ذكر كلمة أي في ما يسميه
المناطقة "دلالة ذاتية"
أو "ذكرا". عندما توجد النحتية
الصياغية (délocutivité )بالمعنى
المعطى هنا لهذا المصطلح،
فان الإشارة إلى ع1 المكون
من المدلول ت 2 ل ع2 ليست
إشارة فقط إلى إنتاج المتتالية
الصوتية ط1 :إنها الإشارة
إلى التزام متلفظ يمكنه
أن يزعم أنه أخذ على عاتقه-
بواسطة الحدث الذي اختاره-
تحقيق الكيان اللساني
ع1 .
لنأخذ في مثال أول للاشتقاق
النحتي الصياغي فعلا
ع1 دالّه ط1 هو شكر و مدلوله
ت1 "تسجيل الثناء" يمكن أن
نصف صلته بالفعل ع2 ذي الدال
نفسه(ط1= ط2= شكر) والمدلول
ت2 "الدعاء بالإثابة" بأنها
اشتقاق نحتي صياغي والواسطة
ستكون العبارة الجاهزة
"شكر الله سعيك" مستعملة
في الرد على معروف وفيها
يصلح الفعل شكر للدلالة
على عمل تسجيل الثناء
(ت1) كما ينجز عملا آخر. يمكننا
إذن أن نقدر تفسيرا لذلك
سواء أكان من زاوية النظر
التاريخية أو بتقدير
العلاقات التي يحسها
المتكلمون الآن لوصف
ت2 باعتباره "قياما بعمل
يمكن لشخص أن يقوم به في
وضعية معينة باستعمال
القوالب الجاهزة السابقة".
وليس من قبيل الاعتراض
ملاحظة أن المدعو له (و
غيره) ينزع وهو يسمع العبارة
الجاهزة "شكر الله سَعْيَكَ"
إلى نسيان الثناء والاحتفاظ
فقط بالدعاء أي إنّه يؤوّل
فعل شكر بوصفه دالاّ ت2
. لأنّ وجود ع1 وع2 المتزامن
يجعل من الممكن دائما
إعادة قراءة ع2 في ضوء ع1
كما لو أنّ ع2 كان حاضرا
من قبل مختوما في القوالب
الجاهزة التي يشير إليها.
ويوفّر لنا مجال أسماء
الأفعال، وهو مجال لساني
مختلف جدّا عمّا كنّا
فيه، مثالا ثانيا على
إلحاق قيم مرتبطة بالحدث
التلفظي، بدلالة الكلمة.
هب ع1 كلمة يحيا معتبرة
مضارع الفعل حيِيَ مستعملة
بالمدلول ت1 (="الدعاء بالحياة)،
في قوالب مثل يحيا الملِك!
، تصلح تلك الكلمة وهي
تدلّ على تمنّي حياة طويلة
للملك، للقيام بعمل لا
قولي مخصوص، يتمثل في
التعبير عن الولاء. ممّا
خوّل لـيحيا أن تصبح كلمة
جديدة ع2 ، تكوّن صنفا من
أسماء الأفعال قيمتها
ت2 ببساطة هي إظهار التعلّق
الولائي للمتلفظ بالأمر
المذكور بعد يحيا. فما
يظهر إنما هو ع2 في تحيا
الحرب! (الموت، الكهرباء،
الخ.). أكثر من ذلك مثلما
هو الأمر في المثال السابق،
فانّ إعادة قراءة القوالب
البدئية ممكنة تؤدّي
إلى نسيان تمنّي طول العمر
في يحيا الملِك! . و يمكننا
أن نتساءل إذا كان أغلب
أسماء الأفعال ليست أو
لم تكن يوما مشتقّات نحتية
صياغية لجمل تعجّبية
دلالتها ت1 مفقودة تقريبا:
ما يبقى من تلك الجمل هو
عمل منجز بتلفظها هو وظيفة
تلفظها.
عندما تكون عبارة التعجب
في صدارة الاشتقاق النحتي
الصياغي، فانّ المرور
من ع1 إلى ع2 يلوح سعيا من
علامة ذات محتوى"أكثر
موضوعية" إلى علامة ذات
محتوى"أقل موضوعية".و لكن
العكس هو الذي يقع عندما
تكون عبارة التعجب عند
الانطلاق(نوع من الاشتقاق
اكتشفه بنوا دي كورنوليي(Benoît
de Cornulier). هب أنّ شيطان! صوت تعجّب
ع1 قيمته الدلالية ت1 وسم
حيرة المتلفظ إزاء حدث
"يتجاوزه". و من ع1 اشتُقّ
حسب كورنوليي الاسم المنسوب
شيطانيّ ع2 و مدلوله ت2 ذو
هيئة أكثر "موضوعية". إنّه
يشبه المكثّفات مثل عبقريّ،
جنونيّ. و يمكننا أن نكشف
هذا الفعل بوصف ت2 بالطريقة
التالية: بتعديلنا اسما
بواسطة شيطانيّ نُشعِر
بأنّ الصفة المعبَّر
عنها" تقتلع" من المتلفظ
صوت التعجّب شيطان! فالعمل
الشيطاني هو عمل شديد
المكر بحيث لا يمكنني
أن أمنع نفسي و أنا أقدّمه،
من القول و النطق بـشيطان!
فالأمر يظهر بوصفه منعوتا
بواسطة الخطاب المقام
حوله.
فأن يكون المدلول المحدّد
عبر الاشتقاق النحتي
الصياغي سواء من مجال
الهيئة أو الملكية، فانّه
يُثبت نزوع اللسان إلى
إدراج القيم المنتجة
عبر الحدث التلفظي ضمن
دلالاته. تتمثل إحدى مسائل
علم الدلالة الراهن في
تقرير ما إذا كان ثمة دلالات
أولى ليس لها أصل معيّن،
أو ما إذا كان المَقُول
ليس دائما ضربا من بلورة
القول. مهما كانت الإجابة،
فانّه توجد في اللسان
إحالات على التلفظ لفهم
أنّ المتكلمين في الخطاب
يشيرون بلا انقطاع في
حدث كلامهم نفسه إلى أنّهم
يتظاهرون و يتفاخرون
أثناء الحديث و يسلسلون
ملفوظات كلامهم لا فقط
بالنسبة إلى المعلومات
التي تنقلها ولكن أيضا
بالنسبة إلى الوقائع
التي تكوّنها.
*المصدر:
- أوزفالد ديكرو:التلفّظ،
فصل في دائرة المعارف
الكونية الفرنسية، الجزء8،
1990، ص-ص.388-392.
Oswald Ducrot: Enonciation, article in Encyclopaedia Universalis, corpus8, 1990, p-p.388-392.
education bahrain
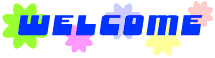
|

